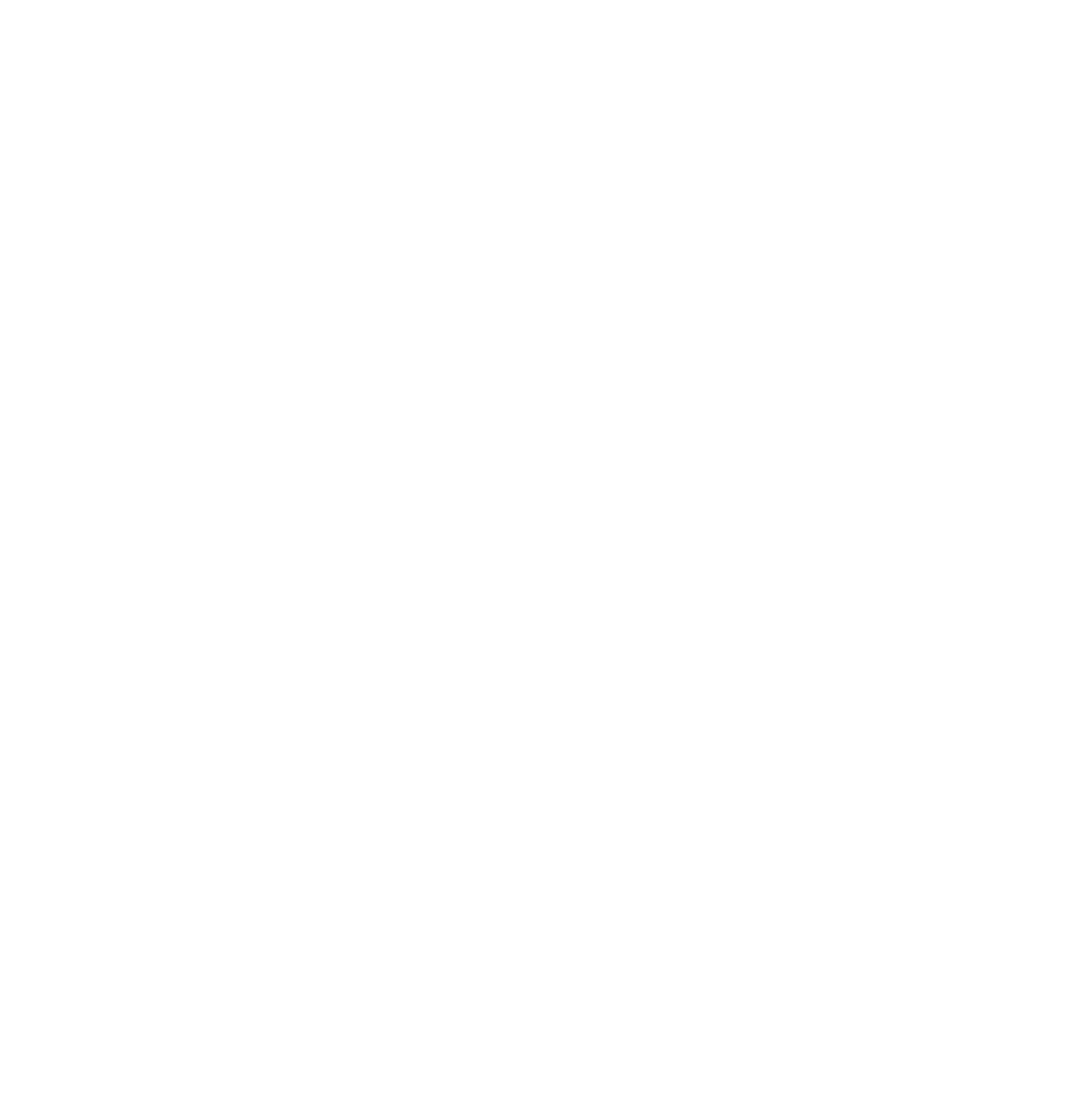يشهد الإعلام المعاصر تحوّلًا جذريًا في بنيته ووظائفه بفعل التقدّم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد دور هذه الوسائل يقتصر على نقل المعلومات، بل أصبحت أنظمة ذكية تتفاعل مع الجمهور وتُعيد تشكيل طبيعة المحتوى ومسارات التأثير. وفي ظل هذا التحوّل، تتداخل التحديات بالفرص؛ فمن جهة، يوفّر الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة في تسريع الإنتاج الإعلامي وتحليل البيانات وتخصيص التجربة الاتصالية، ومن جهة أخرى، يفرض إشكالات نظرية وأخلاقية حول مصداقية الرسائل، وانحياز الخوارزميات، وتغيّر أدوار الفاعلين في العملية الإعلامية.
من هنا تتعاظم الحاجة الأكاديمية إلى تحليل هذه الظواهر في ضوء نظريات الاتصال الجماهيري، لفهم كيف تؤثر الأدوات الذكية في تشكيل الرأي العام، وتوجيه الأجندات، وصياغة الواقع. وانطلاقًا من ذلك، يسعى هذا المقال إلى ابراز تحوّلات الإعلام الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي في قراءة نقدية تستند إلى نماذج تفسيرية كلاسيكية ومعاصرة، مع ربطها بأمثلة واقعية ولما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الإعلام في بيئة تكنولوجية.
1.الذكاء الاصطناعي ونظرية حارس البوابة الإعلامية:
تُعدّ نظرية حارس البوابة (Gatekeeping Theory) التي طوّرها ديفيد وايت من أهم الإسهامات التفسيرية لفهم دور الصحفي والمحرر في انتقاء المحتوى الإعلامي وتوجيه ما يصل إلى الجمهور. غير أن هذا الدور الكلاسيكي شهد تحولًا جذريًا في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الخوارزميات الذكية هي التي تؤدي وظيفة الحراسة، ليس وفق اعتبارات مهنية أو قيمية، بل بناءً على سلوك المستخدمين وتفاعلاتهم السابقة.
في المنصات الرقمية مثل فيسبوك وTikTok، لا يتم ترتيب المحتوى بناءً على أهميته الإخبارية، بل على أساس قابلية النقر والمشاركة، وهو ما ينتج عنه نظام إعلامي خاضع للتخصيص الخوارزمي، يُحاصر المستخدم ضمن "دوائر معلوماتية ضيقة" تكرّس التحيز وتعزل الفرد عن تعددية المصادر.
تتجلّى خطورة هذا التحوّل في وقائع واقعية مثل زلزال المغرب عام 2023، حين اجتاحت منصات التواصل موجات من الصور والفيديوهات المزيفة، أُنتجت جزئيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وقدّمت سردية إعلامية مشوَّهة سبقَت التغطية الرسمية وساهمت في تشكيل انطباعات مضللة. هنا، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرّد ناقل للمعلومات، بل فاعلًا مباشرًا في صناعة الواقع الإعلامي.
إن هذا التطور يفرض إعادة النظر في المفهوم التقليدي لحارس البوابة، والانتقال نحو مفهوم حديث يمكن تسميته بـ "الحارس الخوارزمي"، حيث تتوزع سلطة التحكم بين أنظمة لا تخضع لمساءلة تحريرية مباشرة، بل تعمل ضمن منطق رياضي وتجاري بحت. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى مساءلة خوارزميات النشر، ليس فقط تقنيًا، بل أخلاقيًا وتنظيميًا، لضمان التوازن بين الكفاءة التقنية والمسؤولية المجتمعية في بيئة إعلامية تزداد تعقيدًا.
2. ترتيب الأولويات وتوجيه الرأي العام في ظل الذكاء الاصطناعي:
تطرح نظرية ترتيب الأولويات (Agenda Setting Theory) التي قدّمها ماكومبس وشو رؤية محورية في فهم التأثير الإعلامي، مفادها أن وسائل الإعلام لا تُخبر الجمهور بما يفكر به، بل بما يجب أن يفكر فيه. في البيئات التقليدية، كان تحديد الأجندة الإخبارية نابعًا من اختيارات تحريرية قائمة على الخبرة والمصلحة العامة. إلا أن هذا الدور لم يعد محصورًا بالمؤسسات الإعلامية، بل تحوّل إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تُحدّد، بناءً على سلوك المستخدمين، ترتيب وظهور المحتوى في الفضاء الرقمي.
في ظل البيئة الرقمية الراهنة، أصبح ترتيب الأولويات الإعلامية يتم من خلال أنظمة ذكية تستند إلى تحليل البيانات السلوكية، والموقع الجغرافي، وسجل البحث والتصفح، مما يعني أن الأجندة لم تعد جماعية الطابع بل شخصية وموجّهة بدقة. فعلى سبيل المثال، عند البحث عن كلمة "أزمة" في محرك غوغل، تختلف نتائج المستخدم في باريس عن نظيره في الرياض، رغم استخدام الكلمة ذاتها. وهذا يعكس كيف تُملي الخوارزميات أولويات التفكير على الفرد، دون أن يدرك أنه يتلقى واقعًا إعلاميًا مُفلترًا.
يتضح هذا التأثير بشكل أعمق في التجارب السياسية الحديثة، مثل الحملات الانتخابية الأمريكية، حيث قامت خوارزميات "يوتيوب" و"فيسبوك" بتوجيه المستخدمين إلى محتوى يتماهى مع مواقفهم المسبقة، ما ساهم في تعزيز الاستقطاب وتضييق النقاش العام. وفي هذه الحالة، لم تعد الأجندة الإعلامية فقط مسألة اختيار، بل أصبحت نتيجة حسابات خوارزمية تُبنى على أهداف تجارية بحتة.
من هنا، تبرز الحاجة الأكاديمية إلى مراجعة مفهوم الأجندة في ضوء هذه التحولات، والتفكير في تطوير إطار نظري جديد يمكن تسميته بـ "الأجندة الذكية" (Smart Agenda)، يُعنى بتحليل كيف تُعيد الخوارزميات صياغة النقاشات العامة وتوجيه الاهتمام الجماهيري، بما يتجاوز السيطرة التحريرية التقليدية إلى نوع جديد من الهيمنة التقنية الصامتة على وعي المجتمعات.
3. الغرس الثقافي وتشكيل "الواقع المصطنع" عبر الإعلام الذكي:
تُعدّ نظرية الغرس الثقافي (Cultivation Theory) التي طوّرها جورج جربنر من أبرز الأطر النظرية لفهم كيف يُشكّل الإعلام المتكرر تصوّرات الجمهور عن الواقع. تفترض النظرية أن التعرض المستمر للمضامين الإعلامية، خاصة في البيئات المنغلقة، يؤدي إلى بناء صورة ذهنية جماعية لا تعكس الواقع الموضوعي، بل صورة مشوَّهة تستند إلى ما يُكرّره الإعلام.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى المشهد الإعلامي، لم يعد الغرس يقتصر على التكرار، بل تطوّر ليصبح عملية نشطة لإنتاج واقع رقمي بديل. فالأدوات الذكية كـ ChatGPT وDALL·E وMidjourney باتت تُنتج نصوصًا وصورًا ومقاطع فيديو تُقدَّم على أنها واقعية، لكنها في حقيقتها انعكاس لبرمجيات وتحيزات البيانات التي درّبت الأنظمة. وهنا ينتقل الغرس من مرحلة "تشكيل تصورات" إلى مرحلة "بناء واقع" موازٍ يزاحم الحقيقة نفسها.
ومن أبرز الأمثلة الواقعية والمُوثّقة حادثة الاتصال الآلي الانتخابي المزور التي وقعت في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية أوائل عام 2024؛ حيث تمّ استخدام تقنية AI voice cloning لتركيب صوت يُشبه صوت الرئيس جو بايدن، يدعو الناخبين إلى عدم التصويت في معركة الحسم. وقد ثبت لاحقًا أن الصوت مفبرك – تم إنشاؤه باستخدام أدوات مثل تلك التي تطورها شركة ElevenLabs – ورغم هذا، تمّ بث الاتصال لآلاف الأشخاص وأسهم في إثارة قلق سياسي واسع .
يفرض هذا التحوّل على الباحثين مراجعة الإطار النظري للغرس الثقافي، والانتقال نحو مفاهيم أكثر تركيبًا، مثل "الواقع المؤتمت"، حيث لم يعد الجمهور يتعرض فقط لرسائل موجهة، بل لبيئات معلوماتية كاملة تولّدها أنظمة ذكية قادرة على التحكم بالمحتوى والزمن والسياق. مما يستدعي تطوير أدوات تحليل جديدة تتجاوز القياسات الكمية التقليدية نحو فهم أعمق لديناميكيات الإدراك والاقتناع في عصر الإعلام الخوارزمي.
4. الاستخدامات والإشباعات والتخصيص المفرط في عصر الذكاء الاصطناعي:
تُبرز نظرية الاستخدامات والإشباعات (Uses and Gratifications Theory)، التي طورها كاتز وزملاؤه، الفاعلية النسبية للجمهور في اختيار الوسائط الإعلامية التي تُلبي حاجاته المختلفة، سواء كانت معرفية أو وجدانية أو اجتماعية. غير أن هذه الفاعلية تشهد اليوم تحوّلًا نوعيًا مع دخول الذكاء الاصطناعي في صلب صناعة وتوجيه المحتوى، حيث لم يعد الجمهور يختار المحتوى بقدر ما يُعاد تشكيل خياراته وفقًا لخوارزميات تتعلّم من سلوكه السابق.
ففي التطبيقات المعاصرة مثل TikTok وNetflix وSpotify، تُبنى التجربة الإعلامية بالكامل على أنظمة توصية ذكية ترصد اهتمامات المستخدم وتغذّيه بمحتوى مخصص لحظيًا. هذا الإشباع السريع يُحقّق رضا آنياً، لكنه يؤدي إلى تضييق الأفق المعرفي ويُقصي الآراء المختلفة، ما ينتج عنه ما يُعرف بـ"الفقاعة المعرفية" أو (Filter Bubble).
على سبيل المثال، عندما يستهلك المستخدم نوعًا محددًا من الأخبار أو الأغاني أو مقاطع الفيديو، تبدأ الخوارزميات بإقصاء كل ما يخالف ذلك الاتجاه، حتى يتحول المحتوى الموجّه إلى مرآة رقمية لرغباته فقط. وهنا تنقلب آلية الإشباع إلى شكل من أشكال العزلة التفاعلية، حيث يصبح الإعلام وسيلة لتعزيز القناعات لا لتحدّيها أو توسيعها.
هذا الواقع يُضعف تدريجيًا الحس الجمعي ويقوّض فكرة "الرأي العام المشترك"، الذي يُعدّ أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية والتعددية. فحين تتحول التجربة الإعلامية إلى تجربة فردانية مفرطة، يُصبح الجمهور أكثر عرضة للتجزئة، ويزداد خطر التفكك القيمي والمعرفي داخل المجتمع.
من هذا المنطلق، تقتضي إعادة قراءة هذه النظرية في ضوء الذكاء الاصطناعي تبنّي مفاهيم جديدة مثل "الإشباع المُوجّه" أو "الاستهلاك الخوارزمي"، لفهم كيف تُعيد المنصات الذكية بناء علاقة الجمهور بالمحتوى، لا كمستهلكين واعين فقط، بل كبيانات تُعاد هندستها لتغذية الطلب وتعزيز الولاء، حتى وإن كان على حساب التنوع والانفتاح.
5. الانتقاء الانتقائي والاستقطاب الخوارزمي:
ترتكز نظرية التأثير الانتقائي (Selective Exposure Theory) على أن الأفراد ينجذبون إلى المحتوى المتوافق مع قناعاتهم، ويتجنّبون ما يخالف توجهاتهم. وفي بيئة الإعلام الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لم يعد هذا الميل مجرد تفضيل فردي، بل أصبح جزءًا من تصميم خوارزمي موجه يضاعف الانغلاق المعرفي، ويُعيد إنتاج الانحياز داخل ما يُعرف بـ"فقاعات التصفية" أو (Filter Bubbles).
فعلى سبيل المثال، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2023، لاحظ الباحثون أن المستخدمين في العالم العربي كانوا يتلقّون محتوى مكثفًا حول الضحايا المدنيين والاعتداءات العسكرية، بينما كان المستخدمون في مناطق أخرى، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يشاهدون تغطيات تروّج لرواية "الدفاع عن النفس" وتركز على خطر "الإرهاب". رغم أن الجميع يستخدمون منصات مثل X (تويتر سابقًا)، يوتيوب، وإنستغرام، إلا أن ما يصل إليهم كان يختلف جذريًا، نتيجة خوارزميات تُعيد ترتيب الأولويات بناءً على السلوك والتوجه السياسي المفترض.
يتجاوز هذا التفاوت في العرض مفهوم "التنوع الإعلامي"، ليكشف عن دور الذكاء الاصطناعي كأداة تضخيم انتقائي للرسائل، ما يُنتج مجتمعات معرفية مغلقة، تتعزز فيها الانقسامات الأيديولوجية. لم تعد بيئة المنصات الرقمية مكانًا للحوار المفتوح، بل بُنى معرفية منفصلة تخدم أهدافًا تجارية في ظاهرها، وتحمل آثارًا اجتماعية عميقة في باطنها. وهنا، تتطلب المسؤولية الأكاديمية الدعوة إلى إعادة النظر في تصميم الأنظمة التوصيفية، والبحث عن توازن بين الاستهداف الذكي والعدالة المعرفية، لضمان بيئة رقمية لا تعزز الانقسام بل تسهم في بناء وعي نقدي مشترك.
انطلاقا مما سبق، يمكن القول إن دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي لم يعد مجرد خيار تقني أو تطور عابر، بل هو تحول بنيوي شامل في منظومة الاتصال الجماهيري، أعاد تشكيل العلاقة بين الوسيلة والجمهور، والمحتوى والمعنى، والحقيقة والتمثيل. وقد كشفت نظريات الاتصال التقليدية، حين أُعيد قراءتها في ضوء هذا التحول، عن أبعاد جديدة لعملية التأثير، أبرزها: انتقال أدوار الحراسة والتوجيه من الإنسان إلى الخوارزمية، وظهور أشكال متقدمة من التخصيص الإعلامي الذي يُنتج "واقعًا معرفيًا مصممًا".
لكن هذا التحول لا يخلو من التحديات. فكلما زادت قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الإدراك الإنساني وتوجيه الانتباه، زادت الحاجة إلى يقظة مهنية وتشريعية تضبط مساراته وتُوجّه استخدامه نحو الأهداف العامة، لا المصالح الفردية أو التجارية فقط.
وهنا، تفرض المرحلة الراهنة على الباحثين والممارسين طرح تساؤلات جوهرية تعكس عمق الإشكاليات المطروحة:
• إلى أي مدى يمكن اعتبار الخوارزميات الإعلامية فاعلًا جديدًا في تشكيل الرأي العام، يتجاوز دور الصحفي والمؤسسة الإعلامية التقليدية؟
• هل نحتاج اليوم إلى تطوير نظريات اتصال جديدة تستوعب التفاعل المتسارع بين الذكاء الاصطناعي وسلوك الجمهور الرقمي؟
• ما الدور المطلوب من المؤسسات الإعلامية لضمان التوازن بين الابتكار التقني والمسؤولية المجتمعية؟
• وكيف يمكن بناء إطار أخلاقي وتشريعي دولي يضمن الاستخدام المسؤول والعادل للذكاء الاصطناعي في الإعلام دون أن يتحول إلى أداة للإقصاء أو التلاعب؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تقتصر على الحقل الأكاديمي، بل تتطلب حوارًا متعدد التخصصات يشارك فيه الإعلاميون، والمبرمجون، والمشرّعون، وعلماء الأخلاق، من أجل بناء منظومة إعلامية مستقبلية تُراعي عقل الإنسان، وتعزز الوعي الجمعي، وتحترم القيم الإنسانية في عصر تتزايد فيه سطوة الخوارزميات يومًا بعد يوم.